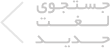
و قرأ حمزة وحده والأرحام بجر الميم، الباقون بفتحها. --التبيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۹۸--
وقرأ حمزة والأرحام بالجر والباقون بالنصب وقرئ في الشواذ والأرحام بالرفع. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۴--
حجّت
من خفف تسئلون أراد تتساءلون فحذف التاء من تتفاعلون لاجتماع حروف متقاربة ومن شدد فقال تَسائَلُونَ فإنه أدغم التاء في السين وحسن ذلك لاجتماعهما في أنهما من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا واجتماعهما في الهمس فخفف هنا بالإدغام كما خفف هناك بالحذف قال أبو علي من نصب الْأَرْحامَ احتمل انتصابه وجهين (أحدهما) أن يكون معطوفا على موضع الجار والمجرور (و الآخر) أن يكون معطوفا على اتَّقُوا وتقديره واتقوا الله واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها وأما من جر فإنه عطف على الضمير المجرور بالباء وهذا ضعيف في القياس. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۴--
وأما القراءة الشاذة في رفع الأرحام فالوجه في رفعه على الابتداء أي والأرحام مما يجب أن تتقوه وحذف الخبر للعلم به. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۵--
وقرئ وَالْأَرْحامَ بالحركات الثلاث.
قراءة ابن مسعود: نسألون به وبالأرحام. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج۱، ص۴۶۲--
حجّت
النصب على وجهين: إما على: واتقوا اللَّه والأرحام، أو أن يعطف على محل الجار والمجرور، كقولك: مررت بزيد وعمراً. وينصره قراءة ابن مسعود: نسألون به وبالأرحام، والجرّ على عطف الظاهر على المضمر، وليس بسديد لأنّ الضمير المتصل متصل كاسمه، والجار والمجرور كشيء واحد، فكانا في قولك «مررت به وزيد» و«هذا غلامه وزيد» شديدي الاتصال، فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة، فلم يجز ووجب تكرير العامل، كقولك: «مررت به وبزيد» و«هذا غلامه وغلام زيد» ألا ترى إلى صحة قولك «رأيتك وزيدا» و«مررت بزيد وعمرو» لما لم يقو الاتصال، لأنه لم يتكرر، وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار ونظيرها. والرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف، كأنه قيل: والأرحام كذلك، على معنى: والأرحام مما يتقى أو والأرحام مما يتساءل به. والمعنى أنهم كانوا يقرون بأن لهم خالقا. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج۱، ص۴۶۲--
قرأ جمهور: السبعة بنصب الميم. وقرأ حمزة: بجرها، وهي قراءة النخعي وقتادة والأعمش. وقرأ عبد اللّه بن يزيد: بضمها. --البحر المحيط فى التفسير، ج۳، ص۴۹۷--
قراءة عبد اللّه: وبالأرحام. --البحر المحيط فى التفسير، ج۳، ص۴۹۸--
حجّت
فأما النصب فظاهره أن يكون معطوفا على لفظ الجلالة، ويكون ذلك على حذف مضاف، التقدير: واتقوا اللّه، وقطع الأرحام. وعلى هذا المعنى فسرها ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم. --البحر المحيط فى التفسير، ج۳، ص۴۹۷--
وقيل: النصب عطفا على موضع به كما تقول: مررت بزيد وعمرا. لما لم يشاركه في الاتباع على اللفظ اتبع على موضعه. ويؤيد هذا القول قراءة عبد اللّه: تساءلون به وبالأرحام. أما الرفع فوجه على أنه مبتدأ والخبر محذوف قدره ابن عطية: والأرحام أهل أن توصل. وقدره الزمخشري: والأرحام مما يتقى، أو مما يتساءل به، وتقديره أحسن من تقدير ابن عطية، إذ قدر ما يدل عليه اللفظ السابق، وابن عطية قدر من المعنى. وأما الجر فظاهره أنه معطوف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار، وعلى هذا فسرها الحسن والنخعي ومجاهد. ويؤيده قراءة عبد اللّه: وبالأرحام. وكانوا يتناشدون بذكر اللّه والرحم.
قال الزمخشري: وليس بسديد يعني: الجر عطفا على الضمير. قال: لأن الضمير المتصل متصل كاسمه، والجار والمجرور كشيء واحد، فكانا في قولك: مررت به وزيد، وهذا غلامه وزيد شديدي الاتصال، فلما اشتد الاتصال لتكرره اشتبه العطف على بعض الكلمة فلم يجر، ووجب تكرير العامل كقولك: مررت به وبزيد، وهذا غلامه وغلام زيد. أ لا ترى إلى صحة رأيتك وزيدا، ومررت بزيد وعمرو لما لم يقو الاتصال لأنه لم يتكرر؟ وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار، ونظير هذا قول الشاعر:
فما بك والأيام من عجب
وقال ابن عطية: وهذه القراءة عند رؤساء نحويين البصرة لا تجوز، لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر مخفوض. قال الزجاج عن المازني: لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان، يحل كل واحد منهما محل صاحبه. فكما لا يجوز مررت بزيدوك، فكذلك لا يجوز مررت بك وزيد. --البحر المحيط فى التفسير، ج۳، ص۴۹۸--
وأما سيبويه فهي عنده قبيحة لا تجوز إلا في الشعر كما قال:
فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا/ فاذهب فما بك والأيام من عجب
وكما قال:
تعلق في مثل السواري سيوفنا/ وما بينها والكف غوط نفانف
واستسهلها بعض النحويين انتهى كلام ابن عطية. وتعليل المازني معترض بأنه يجوز أن تقول: رأيتك وزيدا، ولا يجوز رأيت زيدا وك، فكان القياس رأيتك وزيدا، أن لا يجوز.
وقال ابن عطية أيضا: المضمر المخفوض لا ينفصل، فهو كحرف من الكلمة، ولا يعطف على حرف.
ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان: أحدهما: أن ذكر الأرحام مما تساءل به لا معنى له في الحض على تقوى اللّه تعالى، ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها، وهذا تفريق في معنى الكلام. وغض من فصاحته، وإنما الفصاحة في أن تكون في ذكر الأرحام فائدة مستقلة. والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقدير التساؤل بها والقسم بحرمتها، والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت» انتهى كلامه. --البحر المحيط فى التفسير، ج۳، ص۴۹۹--
وأما قول ابن عطية: ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان، فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه. إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قرأ بها سلف الأمة، واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بغير واسطة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت. وأقرأ الصحابة أبيّ بن كعب عمد إلى ردّها بشيء خطر له في ذهنه، وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري، فإنه كثيرا ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم، وحمزة رضي اللّه عنه: أخذ القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش، وحمدان بن أعين، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد الصادق، ولم يقرأ حمزة حرفا من كتاب اللّه إلا بأثر. وكان حمزة صالحا ورعا ثقة في الحديث، وهو من الطبقة الثالثة، ولد سنة ثمانين وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة، وأم الناس سنة مائة، وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة منهم: سفيان الثوري، والحسن بن صالح. ومن تلاميذه جماعة منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية أبو الحسن الكسائي. وقال الثوري وأبو حنيفة ويحيى بن آدم: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض. وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلع عمر على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ظنا بها وبقارئها، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك. ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون، وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية، لا أصحاب الكنائس المشتغلون بضروب من العلوم الآخذون عن الصحف دون الشيوخ. --البحر المحيط فى التفسير، ج۳، ص۵۰۰--